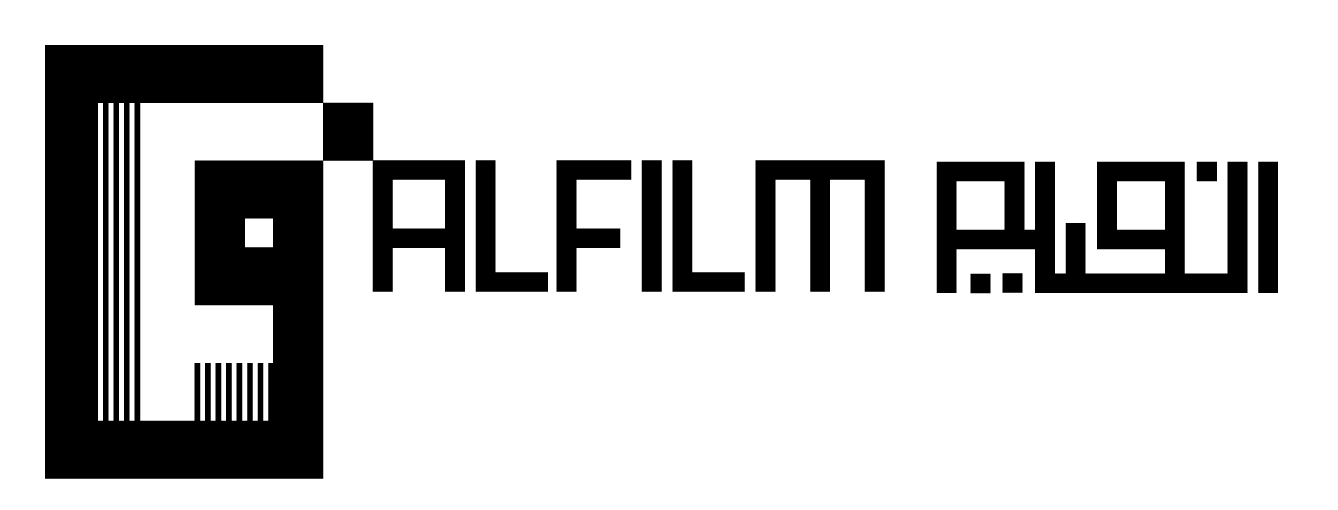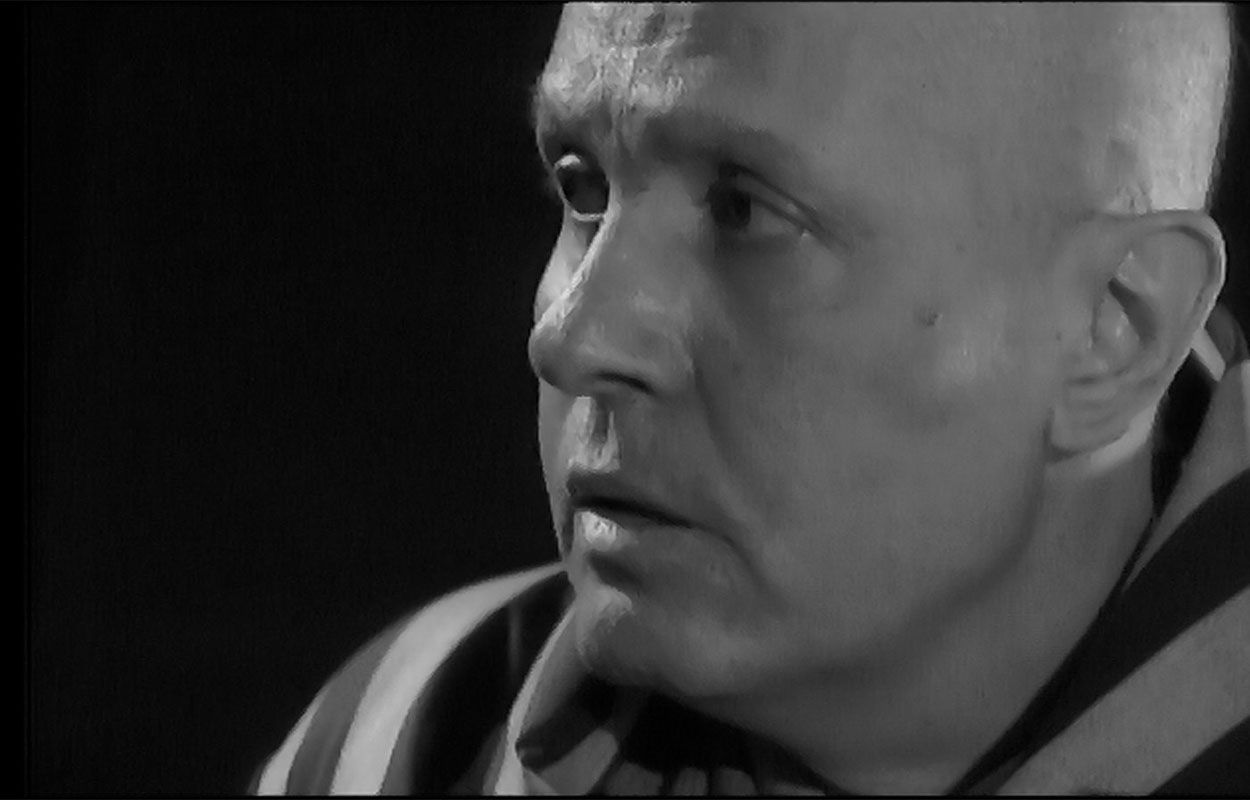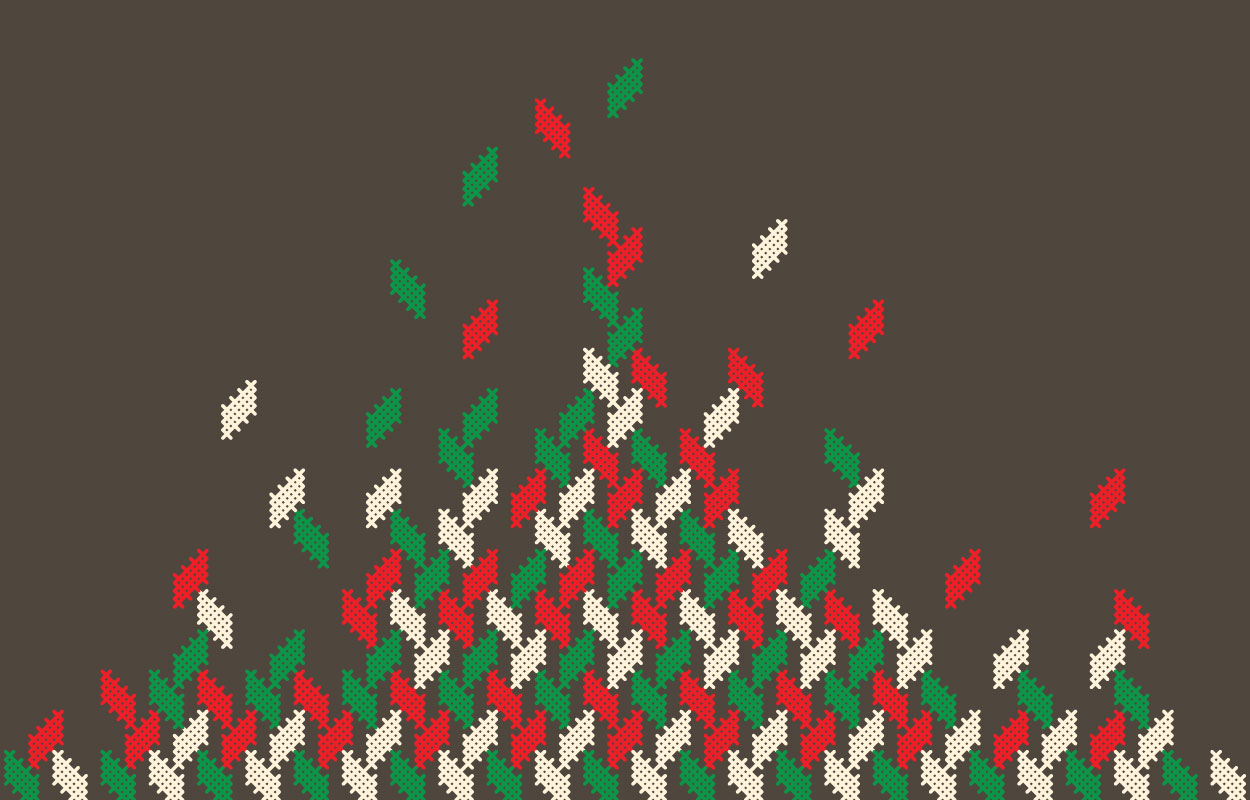بقعة ضوء
هنا هو مكان آخر: فلسطين في السينما العربية وخارجها.
” لا يوجد شي محدد اسمه فلسطين. فلسطين لا حدود لها. فلسطين تتوافر فيها كل العناصر الفوضوية التي تجعلنا نسائل طبيعة المكان، الحدود، المعابر، حتى لو كان لكل ذلك مبررات وجوده”. هذا ما قاله يوما المخرج الفلسطيني الكبير إيليا سليمان في لقاء شهير. وهو قول لا يهدف منه بالطبع إلى إنكار الوجود الفلسطيني أو حق شعبه الأصيل في التحرر الوطني، وإنما إلى إمداد هذا الشعب وقضيته بإمكانيات سردية وجمالية بديلة للتعبير عن الذات، للصمود والمقاومة في ظل ظروف قاهرة، رغم المنفى وموجات التهجير، رغم اضطراب الأوضاع السياسية واستمرارية الاحتلال، رغم ضيق السبل وغياب الحلول.
توجد فلسطين كما نفهم من سليمان وإن أعازتها السيادة الإقليمية. توجد فلسطين حتى وإن افتقرت إلى حدود متفق عليها، إلى معابر ممهدة ومفتوحة. توجد فلسطين في تفاصيل الصور، في تتابعها بعقولنا، في تمثلاتها بوجداننا، فيما احتفظنا به داخل سرائرنا من خبرات وتجارب، في ذكرياتنا، في علاقتنا بالتاريخ، فيما نختلقه من أساليب سردية وشعرية للتعبير، في أشياء عديدة تسافر عبر الأزمنة، لا تخضع لمنطق مكان محدد أو لغة بعينها، تتشابك مع مساعٍ أخرى متمايزة للتحرر وتحقيق العدالة.
فلسطين ليست فقط أرضاً لوطن مسلوب السيادة، فلسطين مسألة تتلاقى حول مداراتها مسارات التاريخ وعصارات تجاربه، مسألة عالمية، تتجلى في كل مكان، هنا، هناك أو في مكان أخر.
استلهاماً لمقولة سليمان، يتناول هذا البرنامج تمثلات فلسطين السينمائية في أماكن أخرى، سواء في المنطقة العربية أو خارجها، مستكشفاً لعوالم التضامن والتعاطف، لرحلات استكشاف الذات وفهم الآخر التي انبثقت داخل سياقات الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية.
***
في فيلمه الأخير إن شئت كما في السماء (2019) يرصد إيليا سليمان الأحوال الهزلية لعالم تمت “فلسطنته” على حد تعبيره، مبايناً بين مسقط رأسه، مدينة الناصرة، ومدن منفاه وترحاله، نيويورك وباريس. يرصد الفيلم رحلة مخرج يتابع كل ما يجري حوله في فضول صامت. يبدو عليه الاغتراب داخل عالم ممعن في العبثية، يمتزج فيه الواقع بالخيال. بينما يصطدم المخرج بالقوالب الجاهزة لما يعتبره المنتجون قصة فلسطينية أو ما يرونه ملائما لمخرج فلسطيني في سياق محاولة لتمويل فيلمه الجديد من جانب، تبدو تجربته الوجودية كفلسطيني من جانب أخر عالقة في إثره أينما ذهب أوحلّ، تتجلى في سياقات العنف المؤسساتي والهواجس الأمنية في كل مكان، في هيمنة أدوات المنع، المراقبة، نقاط التفتيش ومختلف آليات الحوكمة وفرض السلطة. هل تعولمت فلسطين؟
قبل نصف قرن، ربما كان العالم أقل “فلسطنة” مما بدى عليه في نظر سليمان، ولكن فلسطين نفسها كانت بالفعل قد تعولمت وصارت قضيتها مسألة لا يمكن فصلها عن الكفاح الدولي لقوى اليسار وحركات التحرر الوطني. يتضح ذلك سينمائياً عند المخرج الفرنسي الكبير جان لوك غودار (1930-2022)، واحد من أيقونات السينما في العالم وأحد مؤسسي الموجة الجديدة في فرنسا.
فهو بعد مشاركته في إخراج فيلم “بعيداً من فيتنام” (1967) لمساندة المقاومة هناك ضد الامبريالية الأمريكية، يقرر غودار إخراج فيلم عن المقاومة الفلسطينية بمشاركة “وحدة أفلام فلسطين” أطلق عليه اسم “حتى النصر”. سافر غودار بالفعل إلى الضفة الشرقية للأردن وبدأ التصوير مع الفدائيين الفلسطينيين هناك، وقد صرّح في لقاء له مع جريدة فتح الفلسطينية بأن هدفه من هذا الفيلم لا التقاط صور مثيرة ولا إعطاء دروس للشعب الفلسطيني عن معنى الثورة أو وسائلها، ولكن يهدف إلى تعلم دروساً من هذا الشعب، إلى تسجيل هذه الدروس ونشرها في كل مكان. لقد أراد غودار بهذا الفيلم تحقيق رؤيته في تسييس ممارسة صناعة الأفلام وأدوات إنتاجها بدلاً من صناعة أفلام سياسية، على حد تعبيره، وفهم ما يتطلبه ذلك من مراجعات راديكالية لأساليب السرد وآفاق ما تقدمه الصورة. كانت فلسطين بالنسبة لغودار ميداناً لتحويل السينما إلى أداة للمقاومة، للثورة، لتعلم الصمود أمام سطوة الإمبريالية والاستعمار وفي الوقت ذاته – ورغم ما ينطوي عليه ذلك من مفارقة – لتعلم كيف ننهزم ولماذا.
بسبب مذابح أيلول I سبتمبر الأسود عام 1970 التي راح ضحيتها المئات من الفدائيين الفلسطينيين، توقف تصوير فيلم “حتى النصر” بعد أسابيع قليلة من بدايته وعاد غودار إلى باريس. بعد مرور بضع سنوات يقرر غودار إعادة فتح المواد التي قام بتصويرها وخلق فيلم جديدا من وحيها بالتعاون مع شريكة حياته آن ماري ميفيل، فكانت نتيجة ذلك فيلم هنا وهناك الذي ظهر إلى النور عام 1976. يوثق الفيلم للرؤى الأيديولوجية والنشاط الثوري للفدائيين الفلسطينيين في تلك الحقبة، ويعترف في الوقت ذاته بالهزيمة ويكشف عن الفجوة الواسعة بين الأفكار الثورية وواقع الممارسة السياسية، بين عوالم الصورة والحقائق التي تسعى لتصويرها، واضعاً فرنسا وتاريخ الغرب مع العنف في محور تأملات غودار النقدية حول الإمبريالية، الاحتلال واستغلال رأس المال.
المخرج اليوناني الفرنسي كوستا غفراس (م. 1933)، هو كذلك واحد من المخرجين الكبار الذين اهتموا بقضية فلسطين والظلم الواقع على شعبها. فبعد عام واحد من حصوله على الأوسكار عن فيلم “المفقود” عام 1982 أقبل على تنفيذ فيلم حنه ك الذي لعبت بطولته النجمة الأمريكية جيل كلايبرغ أمام الممثل الفلسطيني الكبير محمد بكري في أول أدواره العالمية. يدور الفيلم حول لقاء حنة، المحامية اليهودية بسليم الناشط الفلسطيني الذي يطالب بحقه في استرداد بيت عائلته بينما تتهمه محكمة إسرائيلية بالإرهاب والتسلسل غير الشرعي للبلاد. يثير قرار حنه في الدفاع عن سليم حفيظة النخب السياسية في إسرائيل وردود أفعال واسعة خارجها ويؤثر سلباً على حياة حنه الخاصة مما يدفعها إلى مراجعة قناعاتها واختياراتها الشخصية. تصبح مواجهة الآخر الفلسطيني ومأساته في هذا الفيلم، مواجهة للذات، دعوة لفهم موقعها من العالم، تورطها في قضاياه وعلاقتها الجدلية مع مفاهيم العدالة، النجاح والحب.
التضامن مع القضية الفلسطينية ظل منحاً بارزاً في السينما الأوروبية الوثائقية والروائية لسنوات طويلة بعد ذلك وعلى امتداد المتغيرات التي طرأت على الصراع العربي الإسرائيلي والأماكن المختلفة التي كانت مسرحاً لحوادثه وحروبه. فيلمان وثائقيان في هذا البرنامج يسلطان الضوء على مدينة غزّة التي عانت الأمرين تحت وطأة الحصار المستمر والحروب المتكررة وهما طريق سموني الإيطالي ستيفانو سافونا وأپولو غزّة للسويسري نيكولا فاديموف وكلاهما من إنتاج عام 2018. يسرد سافونا قصة عائلة فلسطينية خرّب القصف الإسرائيلي حقولها العامرة وقتل معظم أفرادها بلغة بصرية حساسة، تصور صمود وكرامة من تبقى من تلك العائلة على قيد الحياة وتعطي مساحة للتعبير لا عن الصدمات التي عاشوها فحسب، بل وكذلك عن أحلامهم/ن التي سرقتها جرائم الاحتلال. أما فادميوف فيطلعنا على غزّة لا يعرفها الكثيرون/ات، غير تلك التي تحكي عنها صور الحرب والدمار كل يوم، فيحكي قصة تمثال إغريقي عُثر عليه مصادفة في البحر بالقرب من أحد شواطئ المدينة، ليصير بعدها لغزاً محيراً تتجسد فيه أحاسيس الفلسطينيين والفلسطينيات بالجمال وآمالهم/ن في سرد تاريخهم/ن، في توثيق صلتهم/ن بإرثهم/ن الوطني والدفاع عن ذاكرتهم/ن الثقافية.
غزّة موجودة كذلك في فيلم الحياة حلوة (2023) للمخرج محمد جبلي، وإن ظهرت فكرة التضامن في الفيلم في شكل وسياق مختلف. فالفيلم شخصي، يتناول رحلة جبالي من موطنه غزّة إلى مدينة ترومسو النرويجية بالقرب من القطب الشمالي، حيث تمت دعوته لحضور فعالية سينمائية هناك. فإذ بحرب جديدة تندلع في وطنه أثناء حضوره ويُفرض حصار قاس على القطاع وتغلق الحدود. تصير ترومسو فجأة منفىً اجبارياً له. إلا أن السلطات النرويجية ترفض تجديد إقامة جبالي الذي يصبح مهدداً بالترحيل خارج البلاد إلى حيث لا يعلم. هنا، يعزم المشهد السينمائي في المدينة سواء من السينمائيين/ات أو الجمهور على دعم ضيفهم/ن الغزاوي والتحالف من أجل مساعدته في البقاء بالمدينة وتحقيق مهمته التي جاء من أجلها وهي تصوير معاناة شعبه ووقائع صموده وعرضها على شاشات السينما في العالم. وثيقة أخرى للتضامن النرويجي مع القضية الفلسطينية نجدها في فيلم وردة (2018) لماتس غرورد. فقد استطاع المخرج النرويجي الذي عاش لسنوات عديدة داخل مخيم برج البراجنة للاجئين/ات الفلسطينيين/ات بالقرب من بيروت من تحويل الحكايات الكثيرة التي رواها له سكان المخيم إلى فيلم رسوم متحركة يعيد سرد أحداث النكبة وتوابعها على أجيال متلاحقة من الفلسطينيين/ات في قالب فني بديع ومؤثر. أما مهند يعقوبي فيطلعنا في فيلمه الأخير الفيلم رقم 21 (2022) على تاريخ مجهول للتضامن مع القضية الفلسطينية وفدائيي حركة التحرير الوطني خارج أوروبا من خلال استعراضه لأرشيف ياباني لمجموعة من الأفلام المصوّرة على شرائط 16مم.
***
للقضية الفلسطينية مكانها المحفوظ في أرشيف السينما العربية منذ البدايات الأولى للصراع العربي الإسرائيلي. فقد كانت القضية حاضرة في الكثير من الأفلام بشكل مباشر كموضوع رئيسي لها، أو تتم الإشارة للقضية في الكثير من الأفلام الأخرى باعتبارها الخلفية السياسية التي تعطي للقصة الرئيسية أو للشخصيات عمقها التاريخي والسياسي. تنوعت وتبدلت السرديات التي تناولت فلسطين ومعاناة شعبها، قضايا الحرب والسلم، النفي والتهجير والمسؤولية المشتركة للأنظمة الحاكمة على الشاشات العربية مع تغيرات الزمن وتقلبات الظروف السياسية. وكثيراً ما واءم السينمائيون والسينمائيات العرب مواضيع وطرائق تناولهم/ن لتاريخ الصراع مع الصهيونية وتأثيره على الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة الأخرى مع المحاذير والأولويات التي فرضتها الأنظمة والظروف الإنتاجية والاقتصادية السائدة.
كانت للسينما المصرية الأسبقية والريادة في تناول قضية فلسطين. فبعد أسابيع قليلة من هزيمة الجيوش العربية في عام 1948 وحدوث النكبة، قامت المنتجة الرائدة عزيزة أمير (1901- 1952) التي تلقب بأم السينما المصرية بإنتاج فيلم “فتاة من فلسطين” الذي صدر في نوفمبر تشرين الثاني عام 1948 وأسندت بطولته للمطربة الصاعدة آنذاك سعاد محمد وإخراجه لمحمود ذو الفقار (1914- 1970) الذي سيصبح في السنوات القليلة التي تبعت هذا الفيلم واحداً من أنجح مخرجي السينما التجارية في مصر. كان هذا الفيلم أول الأفلام التي تناولت الصراع العربي الإسرائيلي في العالم كله. رغم ريادتها الإنتاجية والتقنية في المنطقة، كان على السينما المصرية انتظار قدوم أجيال أخرى من السينمائيين/ات القادرين/ات على تقديم قضية فلسطين على الشاشة بجرأة في الطرح وبرؤية فنية مبتكرة تتجاوز القوالب الدعائية المؤصلة لسرديات الأنظمة والموضوعات المستهلكة تجارياً. كان فيلم المخدوعون (1972) للمخرج المصري الكبير توفيق صالح (1926-2016) نموذجاً لسينما عربية جديدة عن القضية، جريئة الموضوع والأسلوب. استوحى صالح فيلمه من درّة الأدب الفلسطيني، رجال في الشمس لغسان كنفاني، وهو فيلم شخوصه بعيدة كل البعد عن النضالية الرنانة والبطولة الفارغة، تطلعنا رحلتهم مع الشتات على سطوة الهزيمة، على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لمأساة فلسطين وتورط الأنظمة العربية فيما يعيشه شعبها من صنوف العنف والقهر منذ زمن النكبة. عمل أدبي هام آخر بادر المخرج المصري يسري نصر الله (م. 1952) بتحويله إلى فيلم ملحمي صار علامة من علامات السينما في مصر لتميزه على مستوى السرد وجماليات الصورة، وهو فيلم باب الشمس بجزئيه (2004) المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للبناني إلياس خوري. والفيلم يروي بلغة سينمائية أخاذة قصة خمسين عاماً من النضال والصمود الفلسطيني منذ وقوع النكبة، في ظل حياة الشتات والمنفى. عُرض هذا الفيلم في السينمات العربية والعالمية في زمن كانت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في جذوة اشتعالها. فيلم سريدا … امرأة من فلسطين (2004) للمخرجة الكندية المصرية تهاني راشد يتناول الحياة اليومية للنساء الفلسطينيات في هذه الفترة تحديداً، مقدماً وثيقة مهمة تحتفي بقوة عزمهن، بوعيهن السياسي والتاريخي وصمودهن في وجه الاحتلال وممارسات القمع الإسرائيلية.
كانت قضية فلسطين دائمة الحضور كذلك في أعمال كبار المخرجين/ات السوريين/ات من أمثال عمر أميرلاي (1944- 2011) ومحمد ملص (م. 1945) منذ بدايات احترافهم/ن السينما. يستعرض برنامج بقعة ضوء لهذا العام رؤى هاذين القامتين حول القضية الفلسطينية في عرض مزدوج. فيلم وهناك أشياء كثيرة كان يمكن أن يتحدث عنها المرء لأميرلاي يتناول التأملات الأخيرة للكاتب المسرحي السوري الكبير سعد الله ونوس (1944-1997) حول ماض الصراع العربي الإسرائيلي ومستقبله، حول آمال وأوهام جيله من المثقفين/ات العرب فيما يخص القضية في صدق وشفافية من ينتظره الموت. أما المنام (1987) لملص فهو وثيقة لأحلام وكوابيس المهجّرين/ات الفلسطينيين/ات في لبنان حول وطنهم/ن الضائع.
أما في لبنان فقد ارتبطت السينما ارتباطاً وثيقاً بمصائر الفلسطينيين/ات وقضاياهم/ن، ليس فقط باعتبار النكبة، ثم هزيمة 1967، وما تبعهما من حروب وشتات تجارب صاغت الخطوط العريضة للذاكرة الوطنية اللبنانية نفسها، ولكن كذلك لموقع لبنان على جبهة الصراع وخط النار، ومشاركته المباشرة في الكثير من الحروب المرتبطة بالقضية، ثم لوجود مئات الآلاف من اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات على أراضيه. كان المخرج اللبناني كرستيان غازي (1934-2013) أول مخرج عربي يتناول هزيمة 1967 سينمائياً داعياً لضرورة الصمود في فيلم مفقود هو “الفدائيون”. بعده قدم صديقه برهان علويه (1941-2021) فيلم “كفر قاسم” عام 1974 الذي لاقى استحساناً نقدياً ولفت أنظار العالم للسينما اللبنانية. يدور الفيلم حول مذبحة قرية كفر قاسم الواقعة على الخط الأخضر للضفة الغربية والتي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين/ات عشية حرب 1956.
إلا أننا نسلط الضوء في هذا البرنامج على السينمائيات اللبنانيات تحديداً، على رأسهن المخرجة الكبيرة جوسلين صعب (1948 – 2019) التي انشغلت بفلسطين وأوضاع اللاجئين/ات في المخيمات اللبنانية في العديد من أفلامها. في فيلم سفينة المنفى (1982) كانت صعب الشخص الوحيد الذي سُمح له بتوثيق رحلة ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، إلى منفاه الجديد في تونس عبر اليونان، بعد أن أجبرته الحرب الأهلية على مغادرة بيروت، حيث تحاوره صعب في لقطات نادرة على سطح السفينة حول المنفى، حول ما تبقى من وسائل ومعنى الصمود من أجل التحرير. يقدم البرنامج أيضاً فاعلية فنية خاصة بعنوان فلسطين … سردية منقّحة يقوم فيها فنانتان لبنانيتان، هما مهندسة الصوت رنا عيد والملحنة سينتيا زافين، بالتعليق الصوتي والموسيقي الحي على مقاطع من مواد صوّرت على خام 35مم في فلسطين في بدايات القرن العشرين من الأرشيف البريطاني. تهدف تلك التجربة الأدائية والصوتية إلى تفكيك المنطق الكولونيالي لهذه المواد المصوّرة ومساءلة سلطتها في السرد والتمثيل. إضافة إلى ذلك يستضيف البرنامج حلقة نقاش خاصة حول التحديات التي تواجه السينمائيين/ات الفلسطينيين/ات المقيمين/ات في المهجر من سرد قصصهم/ن، حول أشكال التضامن والمراجعات الفنية والمعرفية الناتجة عن تعامل السينمائيين/ات من جنسيات أخرى، سواء عربية أو غير عربية، مع القضية.
في تناولها للقضية الفلسطينية عبّرت السينما العربية عن مصائر الشعب الفلسطيني مع الحروب والشتات، أسهبت في تمجيد صموده ومقاومته، حكت عن الثورات والهزائم، عن الانتفاضات والمذابح، جسدت لحظات اليأس والألم كما جسدت لحظات النصر والأمل. قدمت السينما العربية الفلسطيني والفلسطينية في صورة الثائر/ة المثابر/ة، الحالم/ة المحن/ة إلى ماضيه/ا الضائع، الروح المهزومة، اللاجئ/ة الحائر/ة في تيه الشتات شخوص لم تستطع الآلام والمآسي تبديد كرامتها أو سرقة أحلامها بالتحرير وتحقيق الذات.
ولكن ماذا عن أصول ومنهجية العنف التي تعرض ومازال يتعرض لها الشعب الفلسطيني؟ ماذا عن ممارسات الاحتلال التي تسببت في المعاناة، في المنفى، في فقدان الأمان وفي صدمات نفسية جمعية انتقلت من جيل إلى جيل ومن مكان إلى أخر عبر السنين؟ يأمل هذا البرنامج تناول مسألة الاحتلال ليس فحسب من خلال استعراض آثاره البينة على أجساد الفلسطينيين/ات وفي حيواتهم/ن، وإنما كذلك من خلال تحليل أيديولوجيته، رصد ممارساته وفهم المنطق السلطوي الذي يحكمها والذي عادةً ما يراوغ التجسد والتمثل، ما يغيب عن الصورة في ظل ما يخلقه من عنف ليبقي على فاعليته وتجريده. فيلم آفي مغربي الـ54 سنة الأولى – دليل مختصر للاحتلال العسكري (2021) يأخذ على عاتقه مهمة كشف تلك الممارسات وتجسيدها واضعاً إداريي/ات الاحتلال ومرتكبي/ات جرائمه من جنود وقواد في مركز الصورة لتحليل منهجيته وآليات ادارته.
إسكندر عبد الله
منسق برنامج بقعة ضوء